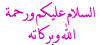
س: تزوجت رجلا
يكبرني بأكثر من عشرين عاما، ولم
أكن أعتبر فارق السن بيني وبينه
حاجزا يبعدني عنه، أو ينفرني منه،
لو أنه أعطاني من وجهه ولسانه
وقلبه ما ينسيني هذا الفارق، ولكنه
-للأسف- حرمني من هذا كله: من الوجه
البشوش، والكلام الحلو، والعاطفة
الحية، التي تشعر المرأة بكيانها
وأنوثتها، ومكانتها في قلب زوجها.
إنه لا يبخل علي
بالنفقة ولا بالكسوة، كما أنه لا
يؤذيني. ولكن ليس هذا كل ما تريده
المرأة من رجلها. إني لا أرى نفسي
بالنسبة إليه إلا مجرد طاهية طعام،
أو معمل تفريخ للعيال، أو آلة
للاستمتاع عندما يريد الاستمتاع.
وهذا ما جعلني أمل وأسأم وأحس
بالفراغ، وأضيق بنفسي وبحياتي.
وخصوصا عندما أنظر إلى نظيراتي
وزميلاتي ممن يعشن مع أزواج يملئون
عليهن الحياة بالحب والأنس
والسعادة.
ولقد شكوت إليه مرة
من هذه المعاملة، فقال: هل قصرت في
حقك في شيء؟ هل بخلت عليك بنفقة أو
كساء؟
وهذا ما أريد أن أسأل
عنه ليعرفه الأزواج والزوجات: هل
المطالب المادية من الأكل والشرب
واللبس والسكن هو كل ما على الزوج
للزوجة شرعا؟ وهل الناحية النفسية
لا قيمة لها في نظر الشريعة
الإسلامية الغراء؟
إنني بفطرتي وفي
حدود ثقافتي المتواضعة لا أعتقد
ذلك. لهذا أرجو أن توضحوا هذه
الناحية في الحياة الزوجية، لما
لها من أثر بالغ في سعادة الأسرة
المسلمة واستقرارها.
والله يحفظكم.
ج : ما أدركته
الأخت المسلمة صاحبة السؤال
بفطرتها السليمة، وثقافتها
المتواضعة هو الصواب الذي جاءت به
الشريعة الإسلامية الغراء.
فالشريعة
أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته
المطالب المادية من النفقة
والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها،
بحسب حاله وحالها، أو كما قال
القرآن (بالمعروف).
ولكنها
لن تغفل أبدا الحاجات النفسية التي
لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها.
كما قال الشاعر قديما:
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
فأنت
بالنفس لا بالجسم إنسان
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
بل
إن القرآن الكريم يذكر الزواج
باعتباره آية من آيات الله في
الكون، ونعمة من نعمه تعالى على
عباده. فيقول: (ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون). فتجد الآية
الكريمة تجعل أهداف الحياة
الزوجية أو مقوماتها هي السكون
النفسي والمودة والرحمة بين
الزوجين، فهي كلها مقومات نفسية،
لا مادية ولا معنى للحياة الزوجية
إذا تجردت من هذه المعاني وأصبحت
مجرد أجسام متقاربة وأرواح
متباعدة.
ومن
هنا يخطئ كثير من الأزواج -الطيبين
في أنفسهم- حين يظنون أن كل ما
عليهم لأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت،
ولا شيء وراء ذلك. ناسين أن المرأة
كما تحتاج إلى الطعام والشراب
واللباس وغيرها من مطالب الحياة
المادية، تحتاج مثلها -بل أكثر
منها- إلى الكلمة الطيبة، والبسمة
المشرقة، واللمسة الحانية،
والقبلة المؤنسة، والمعاملة
الودودة، والمداعبة اللطيفة، التي
تطيب بها النفس، ويذهب بها الهم،
وتسعد بها الحياة.
وقد
ذكر الإمام الغزالي في حقوق
الزوجية وآداب المعاشرة جملة منها
لا تستقيم حياة الأسرة بدونها. ومن
هذه الآداب التي جاء بها القرآن
والسنة:
حسن
الخلق مع الزوجة، واحتمال الأذى
منها. قال تعالى: (وعاشروهن
بالمعروف) وقال في تعظيم حقهن:
(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) وقال:
(والصاحب بالجنب) قيل: هي المرأة.
قال
الغزالي: واعلم أنه ليس حسن الخلق
معها كف الأذى عنها، بل احتمال
الأذى منها، والحلم عند طيشها
وغضبها. اقتداء برسول الله صلى
الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه
يراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة
منهن يوما إلى الليل.
وكان
يقول لعائشة: "إني لأعرف غضبك من
رضاك! قالت: وكيف تعرفه؟ قال: إذا
رضيت قلت: لا، وإله محمد، وإذا غضبت
قلت: لا، وإله إبراهيم. قالت: صدقت،
إنما أهجر اسمك!".
ومن
هذه الآداب التي ذكرها الغزالي: أن
يزيد على احتمال الأذى منها،
بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي
التي تطيب قلوب النساء. وقد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح
معهن، وينزل إلى درجات عقولهن في
الأعمال والأخلاق. حتى روى أنه كان
يسابق عائشة في العدو.
وكان
عمر رضي الله عنه -مع خشونته يقول:
ينبغي أن يكون الرجل في أهله مثل
الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوا
رجلا.
وفي
تفسير الحديث المروي "إن الله
يبغض الجعظري الجواظ" قيل: هو
الشديد على أهله، المتكبر في نفسه.
وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى:
(عتل) قيل: هو الفظ اللسان، الغليظ
القلب على أهله.
والمثل
الأعلى في ذلك كله هو النبي صلى
الله عليه وسلم فرغم همومه
الكبيرة، ومشاغله الجمة، في نشر
الدعوة، وإقامة الدين، وتربية
الجماعة، وتوطيد دعائم الدولة في
الداخل، وحمايتها من الأعداء
المتربصين في الخارج. فضلا عن
تعلقه بربه، وحرصه على دوام عبادته
بالصيام والقيام والتلاوة والذكر،
حتى أنه كان يصلي بالليل حتى تتورم
قدماه من طول القيام، ويبكي حتى
تبلل دموعه لحيته.
أقول:
برغم هذا كله، لم يغفل حق زوجاته
عليه، ولم ينسه الجانب الرباني
فيه، الجانب الإنساني فيهن، من
تغذية العواطف والمشاعر التي لا
يغني عنها تغذية البطون، وكسوة
الأبدان.
يقول
الإمام ابن القيم في بيان هديه -صلى
الله عليه وسلم- مع أزواجه:
"وكانت
سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة،
وحسن الخلق. وكان يسرب إلى عائشة
بنات الأنصار يلعبن معها. وكانت
إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها
عليه. وكانت إذا شربت من الإناء
أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب وكان
إذا تعرقت عرقا -وهو العظم الذي
عليه لحم- أخذه فوضع فمه موضع
فمها".
"وكان
يتكئ في حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه
في حجرها. وربما كانت حائضا. وكان
يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها..
وكان يقبلها وهو صائم".
"وكان
من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من
اللعب ويريها الحبشة، وهم يلعبون
في مسجده، وهي متكئة على منكبيه
تنظر وسابقها في السير على الأقدام
مرتين.. وتدافعا في خروجهما من
المنزل مرة".
"وكان
يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا
خيركم لأهلي".
"وكان
إذا صلى العصر دار على نسائه، فدنا
منهن واستقرأ أحوالهن. فإذا جاء
الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها
بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل
بعضنا على بعض في مكثه عندهن في
القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا
جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير
مسيس، حتى يبلغ التي هو في نوبتها،
فيبيت عندها".
وإذا
تأملنا ما نقلناه هنا من هديه صلى
الله عليه وسلم في معاملة نسائه،
نجد أنه كان يهتم بهن جميعا، ويسأل
عنهن جميعا، ويدنو منهن جميعا.
ولكنه كان يخص عائشة بشيء زائد من
الاهتمام، ولم يكن ذلك عبثا، ولا
محاباة، بل رعاية لبكارتها،
وحداثة سنها، فقد تزوجها بكرا
صغيرة لم تعرف رجلا غيره عليه
السلام، وحاجة مثل هذه الفتاة
ومطالبها من الرجل أكبر حتما من
حاجة المرأة الثيب الكبيرة
المجربة منه. ولا أعني بالحاجة هنا
مجرد النفقة أو الكسوة أو حتى
الصلة الجنسية، بل حاجة النفس
والمشاعر أهم وأعمق من ذلك كله. ولا
غرو أن رأينا النبي صلى الله عليه
وسلم ينتبه إلى ذلك الجانب ويعطيه
حقه، ولا يغفل عنه، في زحمة أعبائه
الضخمة، نحو سياسة الدعوة، وتكوين
الأمة، وإقامة الدولة. (لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة).














